عدالة السماء في الإسلام يوم القيامة لا تخفى عليها خافية، تطلع على كل كبيرة وصغيرة وعلى كل نية وسريرة، تزن بميزان حساس، لا يحابي ولا يختل.
يقول الله تعالى في سورة غافر “الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ * يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ”.
ويقول في سورة الزلزلة “يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ * فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ”.
ويقول في سورة فصلت “وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ”.
لكن قبل الانتقال إلى العالم الآخر والوصول إلى عتبات الحق المطلق، يحاول الإسلام تربية المسلم على معايير العدل في هذه الأرض، آخذاً بعين الاعتبار أنها دار ابتلاء ونقص، لا دار إنصاف وكمال.
فعدالة الأرض مهما بلغت، تبقى نسبية، لا تتطلع على كل التفاصيل، ولا تستطيع الجزم بخصوص النوايا، وربما تتعرض للخداع أو التضليل.
وفي صحيح البخاري، عن أم سلمة أم المؤمنين، عن رسول الله “سَمِعَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ عليهم فَقالَ: إنَّما أنَا بَشَرٌ، وإنَّه يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضاً أنْ يَكونَ أبْلَغَ مِن بَعْضٍ، أقْضِي له بذلكَ وأَحْسِبُ أنَّه صَادِقٌ، فمَن قَضَيْتُ له بحَقِّ مُسْلِمٍ فإنَّما هي قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أوْ لِيَدَعْهَا”.
العلاقة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ينظم كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي حقوق الأفراد وواجباتهم في المجتمع، كما يحددان شروط ونوعية وكيفية تطبيق العقوبات في حالة المخالفة، لكن الفقه يختلف في أنه تفسير بشري للوحي، لذلك ظهرت المدارس الفقهية المختلفة بسبب اختلاف الأفهام لهذا الوحي أو بسبب ترجيح نص ديني على آخر.
فوفقاً لأبي الحسن الرملي في كتابه فضل رب البرية في شرح الدرر البهية (2014) “معرفة الأحكام الشرعية العملية، بأدلتها التفصيلية، سواء كانت بالاستنباط أو بالتقليد أو بالضرورة، فكلها داخلة في الفقه، فهو أعم من الفقه بالمعنى الأصولي”.
أما القانون الوضعي فهو تشريعات وضعها البشر بناء على تجارب الأمم والقيم السائدة في كل مجتمع، وقد يكون ذا مرجعية فقهية معينة أو بدون أي مرجعية دينية.
ويتميز الفقه بأنه لا يُعنى فقط بالعلاقة بين الأفراد وبعضهم البعض، ولكن يهتم أيضاً بعلاقة الفرد بربه، فيحدد مثلاً أركان العبادات وشروطها.
والقاضي في المحاكم المعاصرة يدور في فَلك ما هو متاح أمامه من تشريعات قانونية أقرتها السلطة التشريعية، سواء كانت ذات مرجعية دينية أو غير ذلك، ولا يمكن للقاضي أن يحيد عنها حتى لو كان غير مقتنع بها على المستوى الشخصي، لذلك يرى د. مصطفى يوسف في كتابه مشروعية الدليل في المسائل الجنائية في ضوء الفقه والقضاء (2010) أن “من أهم مظاهر الحياد في التشريع، ما قرره من عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي”.
وقد يتبنى القانون أحياناً موقفاً فقهياً معيناً بناء على ما توافقت عليه السلطة التشريعية بأغلبية البرلمان أو مجلس الشعب، ويكون عادة بَلوَرة لجدل مجتمعي أدى إلى تبني هذا الرأي، لكن في الأنظمة الشمولية يكون موقف الشعب غالباً ثانوي.
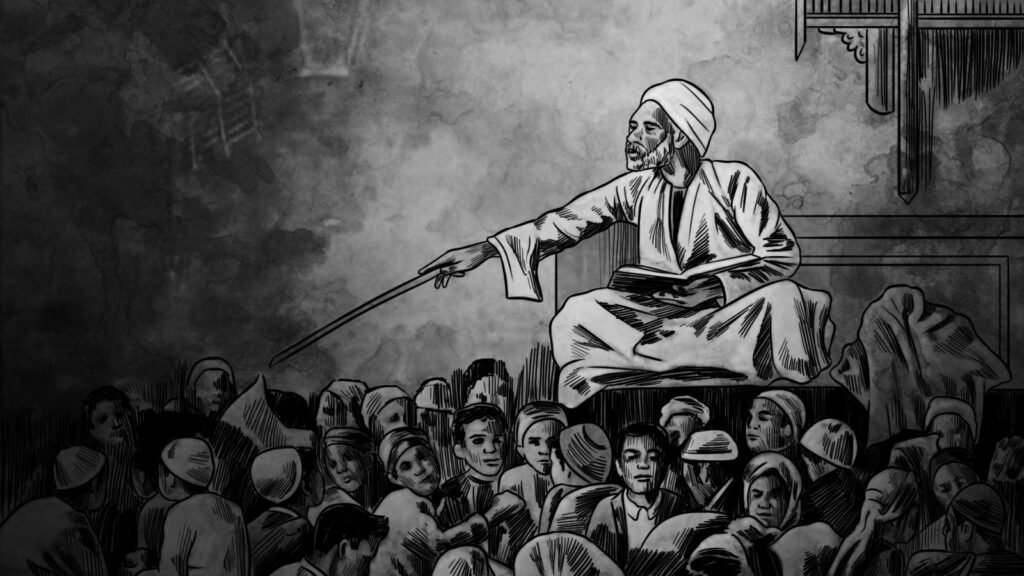
القواعد القضائية في الفقه الإسلامي
تعتمد القواعد القضائية في الفقه الإسلامي على تبني القرائن والأدلة ظنية الثبوت كأساس لبناء الأحكام، خاصة في الحالات التي يصعب الوصول فيها إلى اليقين التام.
فالإدراك وفقاً لجمال صليبا في كتابه المعجم الفلسفي (1994) هو “حصول صورة الشيء عند العقل سواء كان ذلك الشيء مجرداً أو مادياً، جزئياً أو كلياً، حاضراً أو غائباً، حاصلا في ذات المدرك أو آلته”.
ومن هنا يتعامل الفقهاء مع الظن على أن له درجات تتراوح بين اليقين التام والشك المطلق، ويعتبرون غلبة الظن مرتبة بين هذه الدرجات، وهي مقبولة في كثير من السياقات الشرعية كدليل قابل للاعتماد عليه.
ومن أمثلة ذلك، استخدام شهادة الشهود، والقرائن، والتفاصيل المحيطة بالأحداث كأدلة قوية يمكن أن تصل بغلبة الظن إلى درجة تجعل القاضي مطمئناً للحكم، خصوصاً في القضايا التي تتعلق بالحقوق المدنية والتجارية والأسرية، وهو ما يجعله نهجاً مرناً يتيح للقاضي استخدام الأدلة الظرفية والقرائن بشكل واسع لتحقيق العدالة.
وقد أورد الباحث عبدالرحمن محمد جناحي في دراسته للحصول على درجة الماجستير في الفقه وأصوله من جامعة قطر بعنوان بناء الأحكام القضائية على الظن: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي وموقف القانون القطر ي منه (2020) أن الأصوليين والفقهاء اتفقوا “في الجملة على أصل وجوب أو جواز العمل بالظن في الأحكام الشرعية العملية ومنها الإثبات القضائي”.
أما في القانون العام، وخاصة في الأنظمة القضائية الأنجلوساكسونية مثل بريطانيا والولايات المتحدة، يشدد النظام على ضرورة الوصول في القضايا الجنائية إلى مستوى “ما وراء الشك المعقول”، حيث يجب أن يكون القاضي أو هيئة المحلفين مقتنعين تماماً بثبوت التهمة لإدانة المتهم، هذا المبدأ يعكس درجة عالية من الحيطة تجاه الخطأ القضائي، ويتطلب مستوى عالٍ من الإثبات.
في المقابل، لا تتطلب القضايا المدنية في القانون العام نفس الدرجة من اليقين؛ بل يمكن إصدار الأحكام بناءً على غلبة الظن أو “الترجيح”، حيث يكفي أن تكون الأدلة أكثر إقناعاً للقاضي أو هيئة المحلفين مقارنة مع الأدلة المضادة.
ويُعتبر الإثبات عن طريق غلبة الظن في النظام اللاتيني الذي يسود أوروبا والعديد من الدول الأخرى أكثر قبولاً في القضايا المدنية، حيث يكفي أن يكون القاضي مقتنعاً بأن الأدلة المقدمة هي الأكثر احتمالاً في تصوير الواقع، مما يجعله نظاماً أقل صرامة من الأنجلوساكسوني من ناحية اشتراط مستويات اليقين، خاصة في القضايا غير الجنائية.
وقد تأثر القانون القطري بكل من الفقه الإسلامي والتقاليد القانونية الغربية، مما جعله نظاماً مختلطاً يطبق القواعد المستمدة من الشريعة الإسلامية بجانب العناصر القانونية الحديثة، حيث يُعتمد غلبة الظن كوسيلة إثبات، خاصة في القضايا المدنية، فمن خلال استخدام القرائن والشهادات يمكن التوصل إلى الحكم.
ومع ذلك، يشترط القانون القطري في القضايا الجنائية مستوى عالٍ من اليقين، وهو ما يتماشى مع الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون العام.
تكمن التحديات الرئيسية في مواءمة هذه الأنظمة المختلفة، إذ يتعين على القضاة في قطر فهم الفروق الدقيقة بين متطلبات الإثبات في كل من الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية لضمان تطبيق العدالة، بما يتماشى مع السياق القطري، الأمر الذي يتطلب فهماً عميقاً للدرجات المختلفة من الظن المقبولة في كل نظام، وكيفية توظيفها في الإجراءات القضائية بطريقة تتوافق مع مبادئ العدالة وحماية الحقوق.
بشكل عام، يمكن للأنظمة القانونية المختلفة الاستفادة من المفاهيم الإسلامية المتعلقة بالظن، وكيف يمكن أن تساهم هذه المقارنة في تطوير نظام قضائي أكثر تكاملاً وتوازناً، فيستفيد من مرونة الفقه الإسلامي ودقته من جانب، ويواكب التطورات الحديثة في النظم القانونية العالمية من جانب آخر.
رؤية أصول الفقه الإسلامي تجاه غلبة الظن واليقين
إن مفهوم غلبة الظن واليقين من منظور أصول الفقه الإسلامي يوضح أن الفقه الإسلامي يضع أهمية كبيرة على التمييز بين درجات الظن واليقين عند بناء الأحكام القضائية، ففي الفقه الإسلامي، يُعتبر اليقين هو الأصل الثابت والقاعدة الراسخة التي يجب أن تُبنى عليها الأحكام، ولكن في حالات كثيرة، يكون الوصول إلى اليقين التام صعباً أو مستحيلاً، لذا يتم اللجوء إلى غلبة الظن كأداة مقبولة لإصدار الأحكام.
يُعرَّف اليقين بأنه الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه شك، ويعتبر الأصل في بناء الأحكام الشرعية، ويُطبق في القضايا التي تتطلب أدلة قاطعة، مثل الحدود والعقوبات الجنائية، حيث يفسر الشك لصالح المتهم.
فقد ورد في سنن الترمذي عن عائشة أم المؤمنين رض الله عنها عن رسول الله صلى أنه قال”ادْرَؤوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتُم فإن كان له مخرجٌ فخَلُّوا سبيلَه فإنَّ الإمامَ إن يُخطِئ في العفوِ خيرٌ من أن يُخطِئَ في العُقوبةِ.
وتُعرَّف غلبة الظن بأنها الحالة التي يصل فيها القاضي إلى قناعة قوية بناءً على الأدلة المتاحة، ولكن دون الوصول إلى مستوى اليقين، وتُعتبر مقبولة في العديد من الحالات القضائية، خاصة عندما يكون الوصول إلى اليقين غير ممكن.
ويُفَرِّق الفقهاء بين غلبة الظن البسيطة (الراجحة) وغلبة الظن القوية، فالأولى تُقبل في الأمور التي لا يترتب عليها حقوق خطيرة مثل بعض المعاملات المدنية، أما غلبة الظن القوية فتُقبل في قضايا الأسرة والوصايا.
يُطبق الفقه الإسلامي مفهوم “غلبة الظن” بشكل واسع في قضايا الأسرة، مثل النفقات، والنسب، والطلاق، وعلى سبيل المثال، في مسألة النسب، قد تُستخدم قرائن قوية وظروف محيطة لتعزيز غلبة الظن، مثل شهادة الشهود ونتائج الفحوصات الطبية.
وتُعتبر “غلبة الظن” في الفقه الإسلامي قاعدة أساسية في المعاملات المالية والمدنية، كما تُقبل في الحالات التي تُساعد على تسوية النزاعات المدنية وتحديد الحقوق والواجبات المالية، مثل تقدير الديون أو إثبات صحة العقود.
وبالرغم من اعتماد الفقه الإسلامي على اليقين في الأحكام الجنائية، فإنه لا يغفل بالكلية عن مفهوم “غلبة الظن”، ففي بعض الحالات التي تتعلق بالجنايات دون الحدود (مثل القصاص)، تُقبل “غلبة الظن” إذا كانت الأدلة المتاحة قوية بما يكفي لإثبات الجريمة دون الوصول إلى الشك المعقول.
يطبق الفقه الإسلامي منهجاً متوازناً في التعامل مع الأدلة، حيث يعتمد على التدرج في الإثبات، مبتدئاً باليقين، ثم الانتقال إلى غلبة الظن، وفي حالة عدم توفر الأدلة اليقينية، يلجأ إلى الاجتهاد الفقهي والقياس، هذا المنهج يعكس مرونة الفقه الإسلامي في التعامل مع الوقائع المتغيرة والظروف المختلفة.
تُعتبر الشهادات من الأدلة القوية في الإسلام، ولكن إذا لم تكن كافية للوصول إلى اليقين، يمكن دعمها بالقرائن، وهي مجموعة من الأدلة غير المباشرة التي تقوي الشهادة وتصل بالحكم إلى غلبة الظن المقبولة.
كما يُلجأ للاجتهاد في الحالات التي تكون الأدلة فيها غير كافية للوصول إلى حكم قطعي، هنا يُستخدم القياس كوسيلة لتطبيق الأحكام على مسائل مشابهة لتلك التي تتوافر فيها أدلة يقينية.
ويراعى في الفقه الإسلامي نوع القضية وطبيعتها عند تحديد درجة الظن المقبولة، ففي القضايا المالية والأسرية، يُقبل الظن الراجح بناءً على الأدلة المعتبرة، بينما في القضايا الجنائية، يتطلب الأمر درجة عالية من اليقين، مع السماح باستخدام غلبة الظن في القضايا التي لا تتطلب حدوداً قطعية.
يتميز الفقه الإسلامي بنظام إثبات مرن ومتوازن، يهدف إلى تحقيق العدالة من خلال مراعاة طبيعة الأدلة المتاحة وتكييفها وفقاً لمستوى الظن المناسب للسياق القضائي، وهو ما يعزز فاعلية النظام القضائي الإسلامي في التعامل مع الوقائع المعقدة والمتغيرة.
وعليه يرى جناحي في رسالته نفسها أن هذا الاختلاف في أهمية الأخذ بالظن تؤثر “على درجة حماية المرجحات الأولية للمدعى عليه في هذه الأنظمة، فبينما يكفي أدنى رجحان لجانب المدعي لتزول عنه تلك الحماية في المدرسة الأنجلوسكسونية، فإن المدعى عليه في المدرسة اللاتينية وفي الفقه الإسلامي يتمتع بدرجة حماية أكبر لوضعه القانوني، إذ لا يجوز تغييره بغير ظن غالب”.
إضافة إلى أن موقف القاضي يتغير أيضا من وجهة نظره “فبينما يكتفي القاضي الأنجلوسكسوني بحدوث أدنى رجحان في نفسه، فإن القاضي اللاتيني والإسلامي سيحرص على نفي التردد الذي قد يصحب ذلك الرجحان بما لديه من وسائل إثبات، كتوجيه يمين الاستظهار أو تحليف الشهود، فإن لم ينتف التردد ويتحقق الاطمئنان وتسكن النفس فلن تقبل دعوى المدعي ولو ترجح جانبه”.

تأثر القوانين الوضعية بالفقه الإسلامي
يوجد تداخل كبير بين الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية الحديثة من حيث درجة الظن المطلوبة في القضايا الجنائية، إلا أن هذا التداخل لا يعني بالضرورة تطابقاً كاملاً، بل يكشف عن نقاط التقاء واختلاف تتباين وفقاً لنوع القضايا ومعايير الإثبات المختلفة.
فمثلاً، يُشترط في القضايا الجنائية في كل من الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية الحديثة، وخاصة القانون العام، درجة عالية من اليقين لإدانة المتهم، إذ يتطلب القانون الجنائي التقليدي في الفقه الإسلامي الوصول إلى مستوى “اليقين التام” في حالات الحدود والقصاص، هذه القاعدة تتوافق بشكل كبير مع مفهوم “ما وراء الشك المعقول” في القانون العام، الذي يتطلب أن تكون الأدلة قوية وكافية لدرجة لا تترك مجالًا للشك في إدانة المتهم.
يعتمد الفقه الإسلامي على الشهادات والبينات كوسائل أساسية للإثبات، إلى جانب الإقرار واليمين، مع التأكيد على ضرورة التأكد من صدق الشهادات ومدى تطابقها مع الواقع، في حين أن الأنظمة القانونية الحديثة تركز بشكل أكبر على الأدلة العلمية والشهادات، إلا أن المعيار النهائي لكلا النظامين يظل هو درجة الثقة في الأدلة والقدرة على إثبات الجريمة دون أدنى شك.
وعلى الرغم من هذا التداخل في القضايا الجنائية، توجد اختلافات واضحة في القضايا المدنية بين الفقه الإسلامي والقانون العام والقانون المدني، فيجيز الفقه الإسلامي في المسائل المدنية بناء الأحكام على غلبة الظن في حالات كثيرة، خاصة في الأمور التي لا تتعلق بالعقوبات أو الحقوق الكبرى، مثل بعض المعاملات المالية والأحوال الشخصية، ويعتمد هذا النهج على اجتهاد الفقهاء وتفسيرهم للنصوص الشرعية بما يراعي المصلحة العامة ورفع الحرج.
أما القانون العام، فهو يتطلب درجة مختلفة من الإثبات تعتمد على مبدأ “الترجيح”، حيث يُكتفى بأن تكون الأدلة تميل لصالح طرف أكثر من الطرف الآخر دون الحاجة لليقين التام. بينما يحدد القانون المدني معيار الإثبات بشكل عام بضرورة توافر أدلة كافية وموضوعية، مع التركيز على الأدلة الوثائقية والشهود.
ويظهر القانون القطري تأثراً مختلطاً بين الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية الغربية، خاصة في المسائل المدنية، فمن جهة يستمد القانون القطري الكثير من مبادئه من الشريعة الإسلامية، مما يجعله قريباً في كثير من النواحي من الفقه الإسلامي، خاصة في الأحوال الشخصية وبعض المسائل المدنية الأخرى، ومن جهة أخرى، يتأثر أيضاً بالقوانين المدنية الحديثة التي تعتمد على الوثائق والشهادات.
أما في القضايا الجنائية، فيُظهر القانون القطري تشابهاً كبيراً مع الفقه الإسلامي من حيث اشتراط درجة عالية من اليقين لإثبات التهمة، ولكنه أيضاً يتبنى بعض الممارسات الحديثة كاستخدام الأدلة العلمية والتكنولوجية.
أما في القضايا المدنية، فإن بعض الغموض يظهر في طريقة التعامل مع الأدلة ومدى كفاية الظن لترجيح حكم على آخر، ويظهر هذا التباين بسبب الحاجة للتوفيق بين التقاليد الفقهية ومتطلبات الحياة الحديثة التي تستوجب في بعض الأحيان الاعتماد على أدلة أكثر تقنية وتخصصية.
إن أحد التحديات الرئيسية في القانون القطري يكمن في تحقيق توازن بين المحافظة على التراث الفقهي الإسلامي من جانب وتبني الممارسات القانونية الحديثة من جانب آخر، ويواجه هذا التوازن المأمول صعوبة خاصة في المسائل المدنية التي تتطلب إجراءات مرنة وتستند إلى معايير إثبات أقل صرامة مقارنة بالقضايا الجنائية.
إجمالاً، يجب التعمق في كيفية تفاعل الفقه الإسلامي مع الأنظمة القانونية الحديثة، مع التركيز على نقاط التداخل والاختلاف في درجات الظن المطلوبة، مما يسلط الضوء على أهمية فهم هذه الفروق لتعزيز الممارسة القانونية في قطر بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومتطلبات التطور القانوني المعاصر.






[…] الكاتب محمد الغزالي في مقاله الفقه والقانون ومعضلة الظن واليقين إلى أن القواعد القضائية في الفقه الإسلامي التي تعتمد […]
obviously like your web site however you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the truth however I will definitely come again again.