في عالم يتقاطع فيه الملايين يومياً على مفترقات الطرق، تصبح الإشارة الضوئية أكثر من مجرد جهاز ميكانيكي يغيّر ألوانه.
إنها لغة كونية صامتة تنظم حياة المدن وتحفظ أرواح العابرين، فبين الأحمر الذي يوقف الزمن، والأخضر الذي يطلقه، والأصفر الذي يحذر من التحول، تقف حضارة بأكملها على إيقاع الضوء.
ومع تزايد حركة المركبات واتساع شبكات النقل حول العالم، برزت الحاجة إلى توحيد هذه اللغة المرورية وتأسيس قواعد قانونية تنظم السير وتضمن الفهم المتبادل بين سائقين ينتمون إلى ثقافات ودول متعددة.
ومن هنا جاءت الاتفاقيات الدولية لتشكل إطاراً مرجعياً عالمياً يسعى إلى توحيد إشارات المرور وتعريفاتها، وتقنين السلوكيات على الطرق، وتعزيز السلامة العامة.
لكن الطريق إلى هذه الاتفاقيات لم يكن مفروشاً بالأضواء وحدها، بل مرّ بمحطات من الابتكار والتجريب، إذ تحمل الإشارة المرورية في طياتها قصةً تجمع بين العلم والتصميم والتشريع.
الاتفاقية الدولية
مع تزايد أعداد المركبات والمسافرين عبر الطرق حول العالم، ظهرت الحاجة الملحة إلى وضع إطار قانوني عالمي ينظم السير ويعزز من السلامة المرورية.
ومن هنا جاءت اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1968، بوصفها تتويجاً لجهود أممية امتدت لعقود، هدفها توحيد القواعد الأساسية للسير بين مختلف الدول وتيسير حركة المركبات عبر الحدود، مع الحد من الحوادث وضمان فهم مشترك لإشارات المرور وتعليمات القيادة.
انعقد المؤتمر الدولي الذي أنتج هذه الاتفاقية في العاصمة النمساوية فيينا بين السابع من أكتوبر والثامن من نوفمبر 1968، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، وبناء على قرارات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي أكدت ضرورة مراجعة اتفاقية جنيف السابقة لعام 1949 وتطويرها بما يتماشى مع تعقيدات الواقع الجديد في النقل البري.
وقد شارك في المؤتمر أكثر من سبعين دولة، إضافة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقل البري، وغيرها من الهيئات المهتمة بتوحيد المعايير وتعزيز الأمن على الطرق.
ركزت الاتفاقية على تحديد مجموعة من التعريفات والمصطلحات المرورية بشكل دقيق، شملت مفهوم المركبة، والمقطورة، والدراجة، والدراجة النارية، والطريق والممر والمفترق، وحتى حالات الوقوف والتوقف والتقاطعات مع السكك الحديدية.
كما تناولت الاتفاقية تنظيم حركة السير داخل المدن والمناطق المبنية وخارجها، ووضعت أسساً واضحة للتصرف عند التقاطعات وتحديد الأولويات، إضافة إلى تحديد سمات الطريق السريع وشروط استخدامه.
واحدة من أهم محاور الاتفاقية كانت مسألة توحيد إشارات المرور، حيث أقرت أشكالاً وألواناً موحدة للإشارات الضوئية والعلامات التحذيرية والتنظيمية، مما يضمن فهمها من قِبل السائقين بغض النظر عن جنسياتهم أو بلدانهم.
كما تناولت الاتفاقية شروط الاعتراف المتبادل برخص القيادة ووثائق المركبة ولوحات التسجيل، بما يسهّل التنقل الدولي ويخفف من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعيق حركة الأفراد والبضائع.
ورغم الطابع القانوني للاتفاقية، فقد تركت للدول مساحة من المرونة في تطبيق بعض التفاصيل، شريطة الالتزام بالمبادئ العامة التي وردت فيها.
هذا التوازن بين التوحيد والمرونة منحها قابلية واسعة للتطبيق، وساعد على انتشارها واعتمادها من قبل عدد كبير من الدول، ومنها دول الخليج العربي، التي استفادت من معاييرها في تطوير أنظمتها المرورية الحديثة.
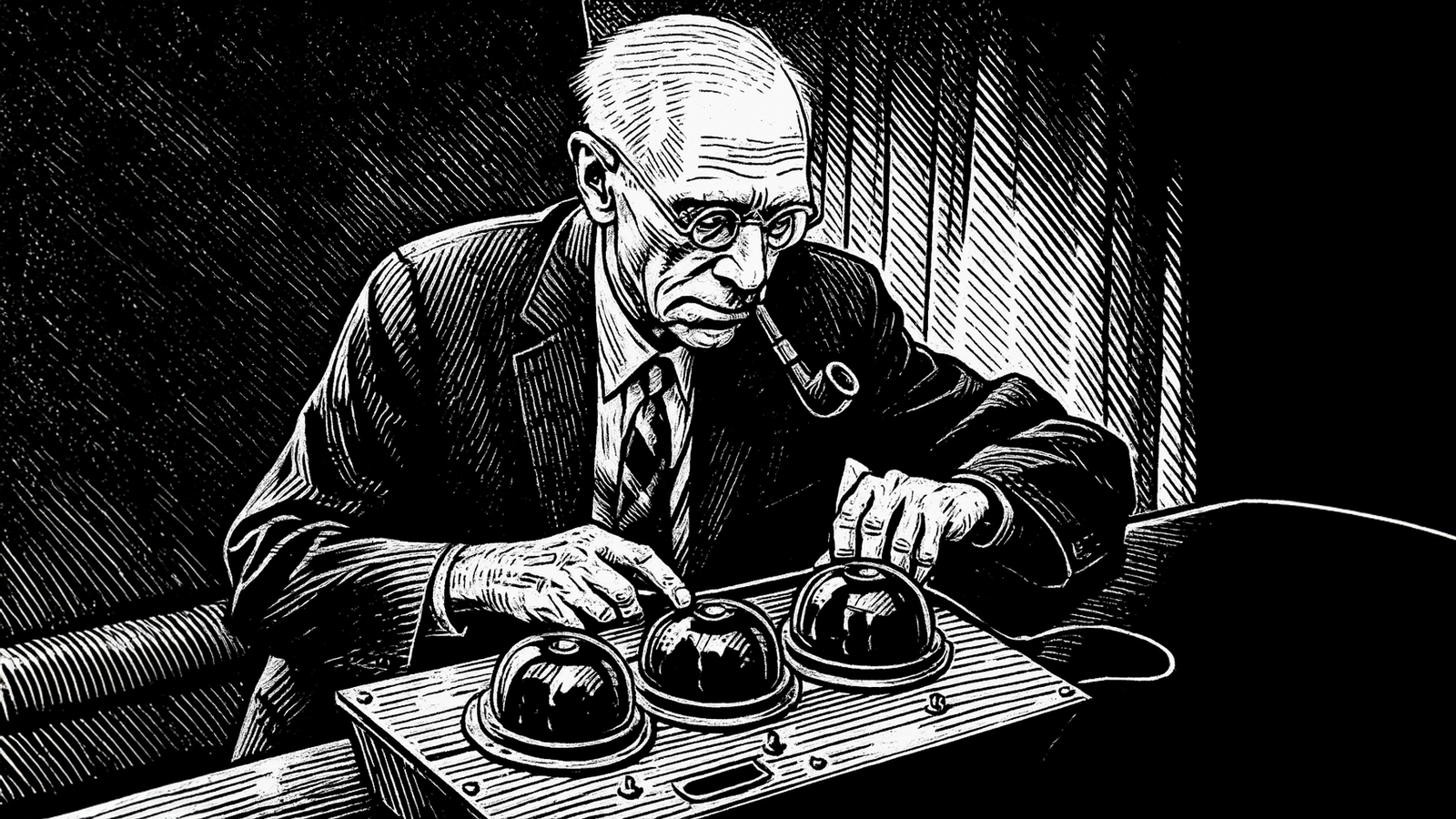
المحاولات الأولى
لم تولد الإشارة الضوئية مع السيارات، بل سبقتها بعقود، فكما تذكر ليز في مقالها المنشور على موقع مجلة آرت بابليكا بعنوان فليكن هناك نور: التصميم المتطور باستمرار لإشارات المرور وما يعنيه ذلك للمستقبل، فإن أول تنظيم لحركة المرور يعود إلى عام 1722 حين تولى ضباط الشرطة تنظيم حركة عربات الخيول على جسر لندن.
كانت محاولة أولى لكنها لم تكن عملية، ومع ازدياد الزحام، ظهرت الحاجة إلى وسائل أكثر كفاءة.
تضيف ليز أن أول إشارة ضوئية حقيقية ظهرت عام 1868، على يد المهندس البريطاني جون بيك نايت، الذي صمّم جهازاً يعمل بالغاز وُضع أمام البرلمان البريطاني، ويجمع بين أذرع سمع فورية وأضواء حمراء وخضراء.
إلا أن الانفجار الذي وقع في المصباح وأدى إلى إصابة شرطي أوقف المشروع مؤقتاً.
في الولايات المتحدة، بدأت المرحلة الحديثة لإشارات المرور مع المهندس إرنست سيرين، الذي حصل عام 1910 على براءة اختراع لنظام إشارات يستخدم أذرعاً مضاءة بكلمات “قف” و”انطلق”.
وفي عام 1912، صمّم المحقق ليستر فاير أول إشارة كهربائية في مدينة سولت ليك سيتي، ثم تم تركيبها فعلياً في كليفلاند عام 1914، كما ورد في المقال.
لكن الإضافة الحاسمة جاءت عام 1917، عندما أدخل الشرطي ويليام بوتس اللون الأصفر بين الأحمر والأخضر، ليحذر من تغير الإشارة.
وفي 1920، صمّم بوتس أول إشارة ضوئية بأربع اتجاهات في ديترويت، مما أسس لشكل الإشارات الذي نراه اليوم في معظم مدن العالم.
ومن الشخصيات اللافتة في هذا المجال غاريت مورغان، المعروف بلقب أديسون الأسود، والذي ابتكر عام 1923 إشارة ضوئية يدوية تضمن توقفاً مؤقتاً بين التبديلات، مما يقلل الحوادث ويتيح عبور المشاة.
وقد باع اختراعه لاحقاً لشركة جنرال إلكتريك بمبلغ 40 ألف دولار، وفقاً لما تذكره ليز.
في عام 1928، جاء المهندس تشارلز أدلر جونيور ليطوّر أول إشارة مرورية تعتمد على الصوت، حيث تتغير الإشارة عندما يطلق السائق بوق السيارة، كما أنه أول من صمّم زراً خاصاً لعبور المشاة.
وفي الثلاثينيات، تم التوصل إلى أول اتفاقية دولية بشأن توحيد إشارات المرور، وذلك عبر اتفاقية جنيف لعام 1931، وفيها تم اعتماد النظام الثلاثي بالألوان: الأحمر، الأصفر، والأخضر.
بحلول خمسينيات القرن العشرين، بدأت إشارات المشاة بالظهور، ثم في السبعينيات ظهرت الرموز التي نعرفها اليوم (الرجل الأحمر والأخضر) لتجاوز حاجز اللغة واعتمدت دولياً في اتفاقية فيينا.
وتختم ليز مقالها بالإشارة إلى التحول نحو إشارات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحساسات، ويمكنها التواصل مع المركبات الذكية وتعديل التوقيت حسب حركة السير والمشاة، بل وقد تصبح يوماً ما غير ضرورية في ظل الاعتماد الكامل على السيارات الذاتية القيادة.

ألوان ليست اعتباطية
في مشهد مألوف لا تخطئه العين، تتوزع إشارات المرور بألوانها الثلاثة – الأحمر والأصفر والأخضر – على مفترقات الطرق في كل مدينة وبلدة حول العالم، مُشكّلة نظاماً بصرياً بديهياً يفهمه الصغار قبل الكبار: قف، انتبه، انطلق.
لكن ما الذي جعل هذه الألوان بالذات تتربع على عرش التنظيم المروري؟ ولماذا لم يتم اعتماد الأزرق للانطلاق أو البني للتوقف؟
في مقال نُشر على موقع ميديام بعنوان لماذا إشارات المرور حمراء وصفراء وخضراء؟، تُطرح هذه التساؤلات لتقودنا في رحلة تاريخية وعلمية ممتعة تكشف أسرار الاختيار.
كانت شركات القطارات في البداية تستخدم الأحمر للتوقف، والأبيض للسير، والأخضر للحذر، إلا أن اللون الأبيض تَسبب في الكثير من المشكلات، إذ كان من السهل أن يختلط على السائقين في الليل مع ضوء النجوم، ما أدى إلى وقوع حوادث مؤسفة.
ونتيجة لذلك، أعيد توزيع الألوان، فأصبح الأحمر إشارة للتوقف، والأصفر للحذر، والأخضر للانطلاق – وهو التسلسل الذي انتقل لاحقاً إلى إشارات المرور في الطرقات.
لكن التفسير لا يقف عند حدود التاريخ، بل يمتد إلى عمق الفيزياء، فوفقاً لموقع ميديام، فإن الضوء يتكون من أطياف لونية مختلفة، تتدرج من البنفسجي الذي يحمل أقصر موجة، إلى الأحمر صاحب الموجة الأطول.
والطيف اللوني الذي يضم الألوان المرورية – الأحمر، والأصفر، والأخضر – يمتاز بقدرة هذه الألوان على الانتقال لمسافات أطول عندما تمر عبر الهواء، خاصة في الظروف المناخية الصعبة مثل الضباب أو المطر.
فالأحمر، الذي يمتلك أطول موجة ضوئية، هو الأنسب لتنبيه السائقين عن بُعد بضرورة التوقف، وهو ما يمنحه “أولوية بصرية” في ظروف الرؤية الضعيفة.
أما الأصفر، الذي يلي الأحمر في طول الموجة، فيعمل كتنبيه أو الاستعداد للتغيير.
ويأتي الأخضر، الذي يمتلك موجة أقصر نسبياً، في المرتبة الأخيرة لأنه يُستخدم للسماح بالحركة، أي حين يكون السائق أقرب إلى الإشارة بالفعل.
يقول الكاتب إن توزيع الألوان على هذا النحو لم يكن محض مصادفة، بل نتيجة لعوامل علمية متداخلة تتعلق بسرعة الاستجابة البشرية، وقدرة العين على التمييز بين الألوان في مختلف ظروف الإضاءة، ومدى بقاء الضوء مرئياً من مسافة طويلة.
من هنا، أصبح الأحمر رمزاً للخطر والتوقف، لا لأنه يثير القلق فحسب، بل لأنه أكثر الألوان قدرة على النفاذ والبقاء في الذهن.
وبذلك، تتجلى عبقرية التصميم في بساطته، إذ يجمع بين العلوم الطبيعية والحس البشري في نظام بصري عالمي لا يحتاج إلى ترجمة، فهناك علم وراء كل شيء، حتى في إشارات المرور التي نراها كل يوم.
عقوبات رادعة
تولي قطر أهمية كبيرة لاحترام الإشارات المرورية، فقطع الإشارة الحمراء قد يؤدي إلى غرامة مالية تبلغ 6000 ريال قطري، إلى جانب تسجيل نقاط على السائق، وربما توقيف المركبة في بعض الحالات.
في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الداخلية القطرية في عام 2018، شدد العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية في الإدارة العامة للمرور، على خطورة مخالفة قطع الإشارة الضوئية، واصفاً إياها بأنها من أكثر المخالفات فداحةً في الخسائر البشرية والمادية، لما تؤدي إليه من وفيات وإصابات جسيمة.
وأكد أن الهدف من الغرامة البالغة 6000 ريال وخصم النقاط ليس مادياً، بل رادع تربوي للمستهترين، مشيراً إلى أن احترام دلالات الإشارة واجب قانوني وأخلاقي، لا يُقاس فقط بوجود كاميرات أو خوف من المخالفة.
أوضح الهاجري أن قانون المرور القطري حدد ألوان الإشارة ودلالاتها بدقة، كما أعطى الأولوية للإشارات اليدوية التي يوجهها رجال الشرطة على الإشارات الضوئية.
ولم يغفل قانون المرور مسؤولية المشاة، حيث فرض غرامة قدرها 500 ريال على من يخالف الإشارات المخصصة لهم، في خطوة تعكس شمولية الرؤية القانونية لضمان سلامة الجميع.
من جانبه، وضح النقيب المهندس محمد مسفر الهاجري، رئيس قسم التخطيط المروري، أن مخالفة قطع الإشارة، ومخالفة السرعة الزائدة من بين الأكثر شيوعاً وخطورة، وأكد أن مخالفة الإشارة تُعد اعتداءً متعمداً على الآخرين، لأنها تتجاهل أمراً صريحاً بالتوقف وتعرض القادمين من الجهة المقابلة للخطر.
وأشار النقيب الهاجري إلى أن إشارات المرور في قطر مجهزة بأنظمة ذكية تعمل بالحساسات، حيث تُعاد برمجتها دورياً لتناسب حجم حركة السير وتخفف من الازدحام. كما شدد على أن تجاوز السرعة، خاصة في الأحياء السكنية ومحيط المدارس، يفاقم من خطورة الحوادث ويعرض أرواح الأبرياء للخطر.
والاستناد إلى تقرير نُشر في صحيفة الراية القطرية بقلم الصحفي إبراهيم صلاح، تم تحديد أسباب رئيسية تقف وراء الارتفاع الملحوظ في عدد مخالفات قطع الإشارة الضوئية.
رصد صلاح آراء عدد من الخبراء والمواطنين في مقاله، وأشار إلى أن التهور والقيادة بسرعات عالية يأتيان في مقدمة الأسباب، يليهما الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة، مما يؤدي إلى تشتت الانتباه وعدم القدرة على تقدير توقيت تحول الإشارة.
فالكثير من السائقين يتجاوزون الإشارة بدافع التهور أو سوء التقدير، وخصوصاً عند تحول الضوء إلى اللون الأصفر، وقد يعود ذلك إلى انشغال السائقين بالشاشات – سواء الهاتف أو شاشة السيارة – أصبح ظاهرة مقلقة تسهم في زيادة هذه النوعية من المخالفات، وهنا تبرز مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة التي قد تسهم في تقليل هذه الظاهرة.
ويقول صلاح أن العديد من الشباب لا يدركون فداحة مخالفة قطع الإشارة، بل ويتعاملون معها باستخفاف رغم ارتفاع قيمة الغرامة التي قد تصل إلى 10,000 ريال أو حتى 50,000 ريال والحبس في حال وقوع حادث جسيم أو وفيات.
ووفقاً لآراء الخبراء النفسيين، يكمن جزء من المشكلة في غياب ثقافة القيادة الآمنة، وتراخي بعض الأسر في توعية أبنائها بخطورة الاستهتار في التعامل مع الإشارات.
لذلك يدعو صلاح إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية شاملة في المدارس الثانوية، خصوصاً للفئات العمرية المعرضة أكثر للتهور، مشدداً على أهمية إشراك ناجين من حوادث مماثلة في هذه الحملات لتكون أكثر تأثيراً.
فإن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء لم يعد مجرد مخالفة مرورية، بل بات مؤشراً على أزمة ثقافة مرورية تحتاج إلى معالجة متعددة المستويات، تبدأ من الأسرة، ولا تنتهي عند القانون.
رغم ما شهدته قطر من تطور في البنية التحتية، من جسور وأنفاق تهدف إلى تسهيل الحركة وتقليل الاختناقات، تظل الإشارة الضوئية عنصراً لا غنى عنه في تنظيم السير.
فبمرونتها وسهولة تعديلها وانخفاض كلفتها، تفرض حضورها بوصفها حلاً عملياً وفعالاً.
وفي النهاية، ليست الإشارة الضوئية مجرد جهاز يلمع ويتبدل، بل هي خلاصة عقود من البحث والتطوير، وشاهد حيّ على رحلة الإنسان نحو التحضر والنظام، إنها ضوء لا ينظم الحركة فحسب، بل يضيء طريق المستقبل.





