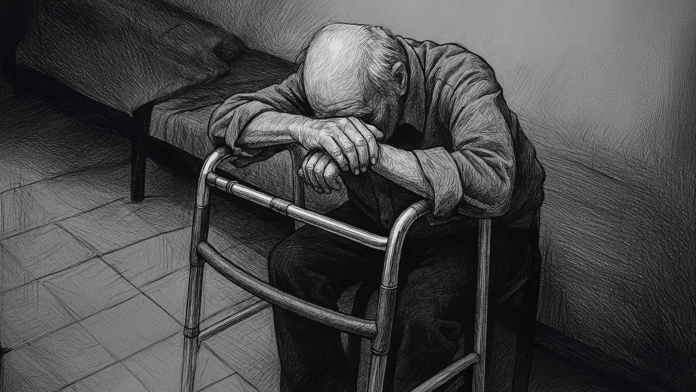في الخامس عشر من يونيو من كل عام، ترفع الأمم المتحدة شعاراً نبيلاً في ظاهره، فتخصص هذا اليوم للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، وتتدفق من منظماتها تقارير وكتيبات ومبادرات تملأ المنصات، تدعو إلى الحماية، وتُظهر التعاطف، وتطالب بالتدخل.
غير أن من يتأمل في هذا الخطاب المكرر ممجوج، ويقرأ ما بين السطور، يجد أن ما يُقدم على أنه إنساني وحقوقي، قد يحمل في طياته رؤية غريبة عن ثقافتنا، بل وربما تهدد صميم العلاقة بين الأجيال، وتؤسس لتبدل في منظومة القيم.
إن أول ما يلفت الانتباه في هذه الحملات هو الإصرار على ألا يُنظر إلى كبار السن على أنهم ضعفاء أو عاجزون، بل يجب – كما تقول الرسائل – أن يُعاملوا كأنهم أنداد، لا فرق بينهم والشباب.
يبدو هذا المبدأ مشرقاً ظاهرياً، لكنه عند التأمل يُفرغ الشيخوخة من معناها، ويتجاهل الفطرة البشرية التي تعترف بأن الكِبر مرحلة طبيعية من عمر الإنسان، لها خصوصيتها واحتياجاتها ورمزيتها.
دور رعاية المسنين
الكِبر ليس عاراً حتى نُطالب بإنكاره، ولا هو هزيمة حتى نُخفيه، بل هو مجد العمر، وخلاصة التجربة، ونقطة التحول نحو الحكمة والسكون والطمأنينة، والإسلام لم يُطالبنا قط بأن نُعامل المسن على أنه شاب، بل أن نُنزله منزلته، وأن نوقّره لكبر سنه، لا رغماً عنه.
حين نتابع توصيات المنظمات الأممية وملاحقها، نلحظ ميلاً متزايداً في نظرة الغرب إلى كبار السن، وهي نظرة – رغم ما تحمله من نوايا تنظيمية – تنبع من رؤية مادية باردة، ترى أن الحل الأمثل لحماية المسنّ هو فصله عن محيطه الأسري، وإقصائه عن المجتمع، ووضعه داخل مراكز ودور تُطرَح كمشاريع استراتيجية دولية، وكأنها النموذج العالمي المثالي القابل للتعميم.
في هذا التصور، تتحوّل الشيخوخة إلى عبء إداري أكثر منها علاقة إنسانية، ويُنظر إلى المسن كحالة تحتاج إلى إدارة، فيُحاط بجدران مؤسسية، ويُخضع لساعات منظمة، وبرامج معدّة مسبقاً، ويُنتزع تدريجيًا من دفء البيت وحنان الأسرة، وتُسوّق هذه المراكز على أنها حل متقدم، ومتحضر، يعكس تطور المجتمع، رغم أنها في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون امتداداً لفلسفة تفكيك الروابط الأسرية، وتكريس الفردانية، والاستعاضة عن البرّ بالأنظمة، وعن الرحمة بالميزانيات.
وفي إحدى المبادرات التي تتناول موضوع الشيخوخة والمجتمعات الصديقة لكبار السن، نرى تجربة بولندية تسعى إلى بناء بيئة داعمة للمسنين الذين ازداد عددهم فيها، ونرى أنهم يحاولون أن يجعلوهم جزءاً فاعلاً من الحياة الاجتماعية، وألا يتم تهميشهم أو عزلهم.
إذ قامت بولندا ببناء 11 مدينة صديقة لكبار السن توفر بيئة داعمة من خلال المرافق، والأنشطة، والسياسات المناسبة، وتشركهم في أنشطة مجتمعية وثقافية مثل التعليم، والإذاعة، والمساعدة المنزلية، والتواصل الاجتماعي.
ما يُقلق في هذا الطرح ليس فقط اختزال الحل في مؤسسة، بل ترويج هذه الفكرة باعتبارها نموذجاً حضارياً متقدماً، وربما يبدو أنه يراعي خبراتهم ولا ينكرها، وربما هو مناسب للحالة التي يعيشونها وللتركيبة السكانية في بلادهم، وهو ما لا نشكو منه، بل لدينا العدد الكافي من الشباب الذين يمكنهم تغطية كل القطاعات دون استثناء.
وليس مطلوب منا نسخ النموذج الغربي كما هو، دون التوقف للحظة واحدة للتفكير في أن الكبار في أوطاننا كانوا، ولا يزالون، يُعاملون كركن من أركان البيت والمجتمع، لا كضيوف عليه.
أين الدعوة إلى تعزيز الأسرة الممتدة؟ أين الجهد التوعوي الذي يدعم الأبناء والبنات على احتضان آبائهم وأمهاتهم في كبرهم؟
الأدهى من ذلك أن كثيراً من الكتيبات والبرامج التوعوية التي تصدر عن هذه المؤسسات تطلب من كبار السن أنفسهم أن يتخذوا موقفاً.
يُقال لهم: لا تقبلوا الإساءة، وتكلّموا، وبلغوا، وتواصلوا مع الجهات المعنية.
هكذا ببساطة، يُلقَى العبء على عاتق المسنّ الذي قد يكون فاقداً للصحة، أو القدرة، أو العون.
أين الأسرة؟ أين المجتمع؟ أين مَن يجب أن يتحرك نيابة عنه؟
الغريب أن هذه الحملات كثيراً ما تصف المعتدين بأنهم من أقرب الأقربين، من الأبناء أو الأحفاد أو الجيران، ثم لا توجّه خطاب التوعية إليهم، بل تبقيه موجهاً نحو الضحية، وهذا الانحراف في الرسالة يعكس خللاً أخلاقياً عميقاً، يجعل المسن لا ضحية فقط، بل مسؤولاً أيضاً عن نجاته.
على سبيل المثال، في أحد المنشورات الخاصة بمركز كاكستون القانوني، نجد قصة امرأة تبلغ من العمر 71 عاماً، تتعرض لسوء معاملة من قبل عائلتها، بما في ذلك السيطرة على أموالها ومنزلها، والإهانات، وأحيانًا العنف الجسدي، ورغم ذلك، يُطلب منها أن تكون المبادِرة بالإبلاغ عن الإساءة، عبر التحدث إلى شخص تثق به في المجتمع، أو الاتصال بخدمة الدعم القانوني للمسنين، أو التواصل مع الشرطة في حالات الخطر المباشر، وهنا نرى نهجاً يُحمّل الضحية مسؤولية اتخاذ الخطوة الأولى، متجاهلاً الصعوبات النفسية والجسدية التي قد تمنعها من القيام بذلك.
ونجد أيضاً في موقع كومباس الإلكتروني الوطني الذي أنشئ لمساعدة كبار السن الأستراليين قصة مشابهة يستضيف فيها أب ابنته التي تعاني من إدمان المخدرات في منزله، ولكن تسوء الأمور عندما تبدأ البنت في التصرف بعدوانية، وتُدخل متعاطين آخرين إلى المنزل، مما يؤثر سلباً على صحة الأب النفسية، على الرغم من ذلك، يُتوقع من بوب أن يتخذ إجراءات قانونية لإخراج ابنته من المنزل، وأن يتعامل مع الوضع بمفرده، مع بعض الدعم من الخدمات القانونية والاجتماعية.

التركيبة السكانية لدى الغرب
وليس الأمر هنا متعلقاً بالوسائل فقط، بل بالفكرة الجوهرية، حين تصف الأمم المتحدة في تقاريرها أن ازدياد أعداد كبار السن خلال السنوات القادمة مشكلة، وأن على الدول الاستعداد لها، فإنها بذلك تعبّر عن رؤية مادية بحتة، تنظر إلى الإنسان من زاوية الإنتاج والكلفة.
فالإحصائيات في موقع الأمم المتحدة تبين أن “بين عامي 2019 و2030، من المتوقع أن ينمو عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر بنسبة 38٪، من مليار إلى 1.4 مليار، وهو عدد يفوق عدد الشباب على مستوى العالم، وستكون هذه الزيادة الأكبر والأسرع في العالم النامي”، ولا أعلم السبب الذي جعله يدعي أن هذه الإحصائيات مرتبطة بالعالم النامي، رغم انها مشكلة في أوربا والدول التي تسمي نفسها متقدمة.
ثم يقول أن “إساءة معاملة المسنين مشكلة موجودة في كل من البلدان النامية والمتقدمة”، وهو لا يعلم إن كانت موجودة حقاً في الدول النامية، إذ يقول إن “لا توجد بيانات عن معدلات الانتشار أو التقديرات إلا في بلدان متقدمة معينة —تتراوح من 1٪ إلى 10٪، وعلى الرغم من أن هناك جهل بمدى سوء معاملة المسنين، فإن أهميته الاجتماعية والأخلاقية واضحة، وعلى هذا النحو، فإنها تتطلب استجابة عالمية متعددة الأوجه، تركز على حماية حقوق كبار السن،” فالأمم المتحدة تحاول إدخال دولنا في مشكلة نحن لا نعاني منها، وتريدنا أن نتبنى استراتيجيات وحملات لا تمت بصلة إلى طبيعة حياتنا وثقافتنا.
فهو يرى أن المسن لا يُنتج، بل يستهلك، وعليه فإن تكاثره عبء، وهذا التصور بعيد عن روح الإسلام، الذي لا يرى في العمر المتقدم إلا خيراً.
فالكِبر في الشريعة بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الخير مع أكابركم”، ولا يُزاد المؤمن في عمره إلا كان خيراً له، وإن كانت الأمم المتحدة ترى المسنين تحدياً ديموغرافياً، فإن الإسلام يراهم ذخراً روحياً واجتماعياً.
لكن الخطر الحقيقي لا يكمن في الخطاب الأممي ذاته، بل في تبنّيه الأعمى داخل مجتمعاتنا، حين تتلقف بعض الدول الإسلامية هذه الرسائل وتترجمها إلى خطط دون تمحيص، فإننا نكون بصدد تحويل ثقافتنا من منظومة إيمانية قائمة على البر والرحمة والتكافل، إلى منظومة ليبرالية مادية علمانية لا مكان فيها للمروءة ولا للنية الصالحة.
ومن ذلك أيضاً أن الخطاب الأممي يوجّه الحديث دوماً إلى كبير السن، يحمّله المسؤولية، ويدعوه للوقوف ضد العنف، بينما في الإسلام يُوجَّه الخطاب دوماً إلى الشاب، ويطالبه بالإحسان والتوقير.
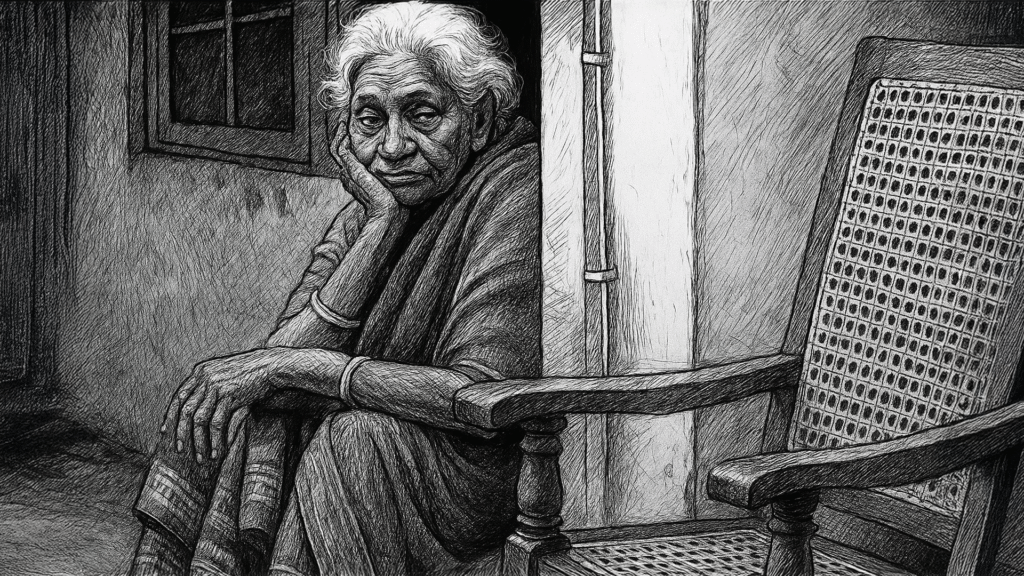
أشكال وأنواع الإساءة
تتعدد أوجه الإساءة التي قد تُلحق بكبار السن، وتتنوع أشكالها كما تتنوع الأيدي التي تُخطئ إليهم، فلا تقف عند ضرب أو صراخ، بل تمتد خفيةً أحياناً، وظاهرةً فجّة في أحيانٍ أخرى، لتحطّ من كرامة إنسان بلغ من العمر مبلغه، وأضحى في أمسّ الحاجة إلى الرحمة لا القسوة، ولا الإهمال.
إن أولى صور الإساءة، وأكثرها وضوحاً، هي الإساءة الجسدية، حين تُوجّه اليد لا للعون بل للإيذاء، فيُدفع الجسد الواهن، ويُصفع، ويُشد، في مشاهد تجردت من كل رحمة، ومعها، تتسلل الإساءة النفسية والعاطفية، وهي أشد خفاءً، لكنها لا تقل ألماً، حين يُهان المسنّ بكلمة، أو يُحتقر بنظرة، أو يُهمل عن قصد، أو يُسلب حقه في اتخاذ القرار، فيُشعر بأنه زائد على الحياة، لا مكان له في مشهدها.
ثم تأتي الإساءة المالية أو المادية، حيث تُمد اليد على مدخراته، تُنفق أمواله بغير إذنه، وتُنتزع أملاكه من بين أصابعه المرتجفة، دون استئذان ولا شفقة، وفي مواضع أخرى، قد لا يُعتدى عليه بشكل مباشر، لكن يُترك دون طعام أو دواء أو دفء، فذلك الإهمال، الذي ينهش حياته بصمت، كأن وجوده لم يعد يُذكر.
أما أقسى الأشكال وأكثرها عدواناً، فهي الإساءة الجنسية، حين يُستغل المسن وقد فقد القوة على الدفع والرفض، في انتهاك يتعدى الجسد إلى الكرامة والروح، وتبقى الإساءة الأشد قسوة في صمتها، تلك التي تُعرف بـ الهجر، حين يُترك الكبير وحيداً، منسياً، بعدما كان يوماً عماد الدار وركنها الركين.
هذه الصور، كما وردت في تقارير منظمة الصحة العالمية، ليست مجرد نظريات، بل هي وقائع تحدث كل يوم، تصرخ في وجه المجتمعات أن استيقظوا، فالكبير لا يريد أكثر من احترامٍ يُردّ له، وكرامةٍ تُصان، ومكانةٍ تُحفظ. وإن تجاهلنا هذا النداء، فنحن لا نخسرهم هم فقط، بل نخسر إنسانيتنا معهم.
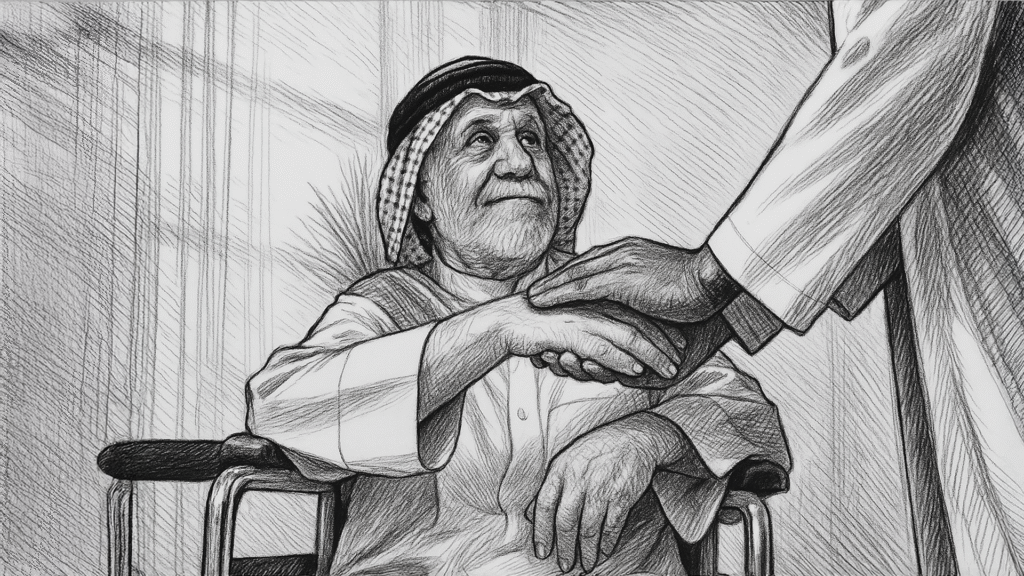
وجهة النظر الإسلامية
في نصوص الشريعة، يُربى الإنسان منذ نعومة أظفاره على أن احترام الكبير من الدين، بل هو من إجلال الله، كما في الحديث: “إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم”، وإن صورة المسنّ في الإسلام ليست صورة من يحتاج للمساعدة فحسب، بل من تجب خدمته حباً وتكريماً.
فهم الذين أعطونا قبل أن نطلب، واحتضنونا قبل أن نعي معنى الحنان، وهم من ربّونا على أعينهم، وكبرنا بخطواتهم، وسقونا من تعبهم وسهرهم وأمنهم.
هم من زرعوا فينا الجذور، وبنوا لنا البيوت، وعلّمونا الحروف والمعاني، وما زلنا – مهما كبرنا – نتعلّم منهم، ومن حِلمهم، ومن أثرهم، فلا يجب أن ننسى من علّمنا كيف نمشي، ولا أن ننسى من كان سندٌ لنا، فلا يمكن أن ننساهم حين تنحني ظهورهم وتثقل أنفاسهم.
هنا يكمن الوفاء لرد بعض الجميل، فنحميهم، ونصون كرامتهم، ولا نتركهم وحدهم مهما طال الطريق، ونرفعهم إلى مقامهم، ونُجلّهم، ونُبشّرهم بأنهم ما زالوا النور في بيوتنا، والبركة في أعمارنا.
فمعهم نكمل الطريق، ممسكين بأياديهم، ونمشي ببطء لا لضعفٍ فينا، بل احتراماً لخطواتهم، وندرك كبرهم في أعيننا، ونجعل لهم سكناً في قلوبنا، ليضيؤوا لنا الدرب بحنانٍ لا يشيخ.
وقد جمع الدكتور محمد بن سليمان الواصل في مقاله كبير السن وحقوقه في الإسلام أن ملامح هذه الرؤية العظيمة التي تتعامل مع الشيخوخة باعتبارها منزلة شرف، لا حالة طوارئ، وبيّن أن إكرام الكبير، والبدء بالسلام عليه، وتقديمه في المجلس، وحسن خطابه، والدعاء له، ليست أعمالاً إضافية، بل حقوقاً واجبة، وأن في الكبير سبباً في طول العمر، وجلب الرزق، وتوفيق الله للعبد، فكما تدين تدان، ومن يكرم كبيراً قيّض الله له من يكرمه إذا شاب.
إن تبنّي النموذج الأممي في التعامل مع كبار السن يجب أن يُراجع بوعي ومسؤولية، فنحن لسنا ضد الحماية، ولا ضد تطوير الأدوات، لكننا ضد تمييع المفاهيم، ونزع القدسية عن الأسرة، وتهميش دور الشاب في منظومة البر، وتحويل الشيخ إلى مجرد رقم في نظام الحماية الاجتماعية.
نحن أمة تقدّس الكبير، وترى فيه النور والبركة، لا العبء والمشكلة، وإن رعاية المسنّ ليست مجرّد واجب قانوني، بل عبادة خالصة لله، ومصدر رضا ورحمة في الدنيا والآخرة.